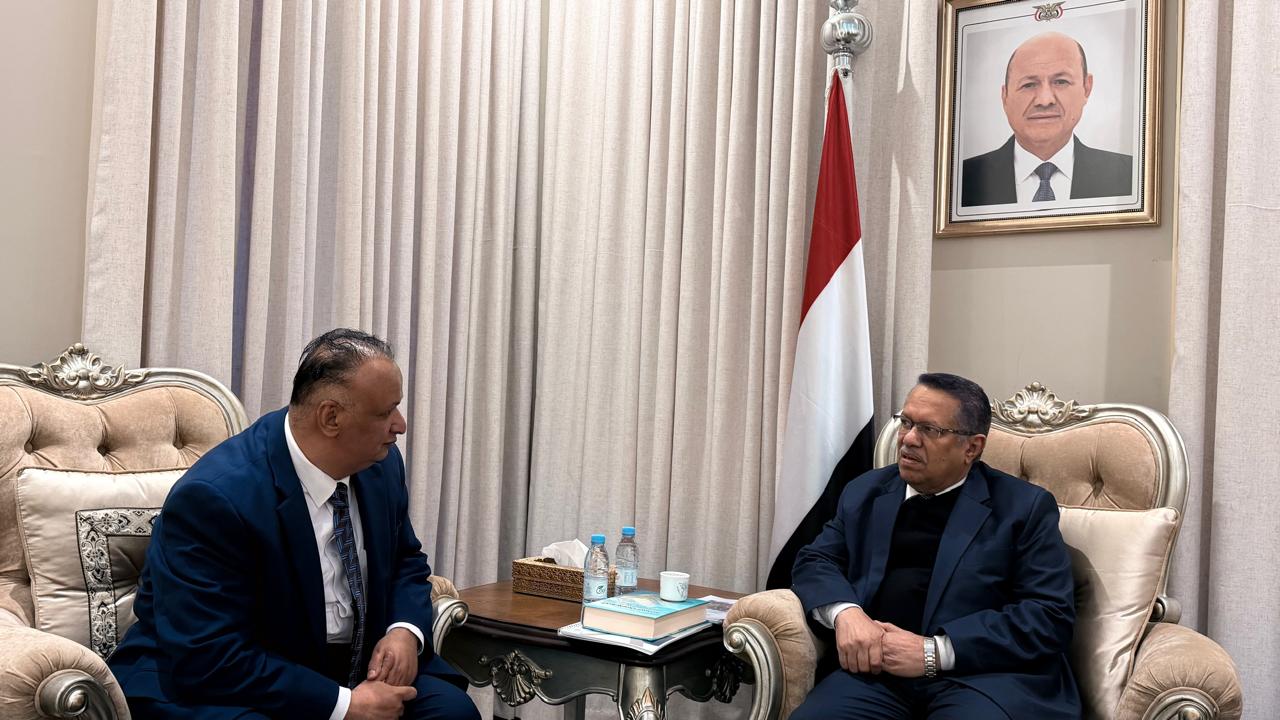- باحثة فلسطينية من غزة
للألم عينُه، وللقصة لسانُها، والعين تروي بدمعها ما لا يمكن للِّسان أن يحكيَه. والحربُ في غزة امرأةٌ حبلى بوجعٍ دائم، ومخاضٍ عسير، لا تلد بعده إلا جنينًا مشوّهاً.
والإنسانُ قد اعتاد الكلام؛ في محاولةٍ لنسف جبال الحزنِ الجاثمةِ فوق صدرِه، وإيقافِ الخصومِ المتناحرةِ الجاثيةِ على جسدِه. وحدها الكتابةُ صيّادة الفرائس، قد تصيبُ وقد تخيب!
أستيقظُ كلّ يومٍ لأتلقّى وعدي: “الهربُ من التابوت، والعودةُ إليه”. فالبلدُ كلّها مقبرةٌ وجثثٌ دون دفنٍ أو جنازاتٍ، قد تقصدك صواريخ مقاتلات F16 فتموت في بيتك، أو تُجهز عليك طائرات الجيش المسيرة في طريقك؛ للبحث عمّا يسكت الجياع من طعام، أو أثناء عملك في مراكز الإيواء النازحين الذين طبّق عليهم الجيش “الإنساني” كل معايير الإنسانية والأخلاقية!
أنقلُ -صباحًا- جالونات المياه في رحلةٍ يومية كُتبَت علينا مؤخرًا، في عودةٍ غير متوقعة إلى حكايات الجدات عن نقلهم الماء من النبعةِ في البلاد، ولقاء الأحبة هناك، وعلى النقيض-اليوم- فلا أغانيَ نرددها للواردات إلى المياه في رحلة العذاب هذه، ولا إلى الخارجين والخارجات في رحلة التّحطيب، شتّان بين مكرَهٍ وراضٍ، وبين وجِلٍ وآمن، وبين مقيمٍ ونازحٍ.
بعدها أمشي صباحًا – كل يومٍ- هاربةً من حرّ البيوت بفعل الطبيعة ومستحدثات الحياة الطارئة من النار المشتعلة، وتكدّس الأصحاب والنازحين فيما تبقى من دورٍ. أدس رأسي في الحاسوب بين ملفات النازحين وبياناتهم، وأحشر جسدي بين طوابيرهم، وأوراقهم، ومعوناتهم، نتلقّف دعواتهم، ونردّ في سرنا شتائمهم، فالحرب -مع كامل الاعتذار لمن يريد إخراج غزة في صورة مغايرة- قد أخرجت أسوأ ما في الإنسان، وأيقظت فيه فردانيته وأنانيته، وبحثه عن مصالحه الشخصية، كثرٌ يلهثون وراء دنياهم، متغاضين عن شبحِ الموت الذي يلاحقهم، أو كأنهم أدركوا قرب النهاية فأرادوا أن يستحوذوا على كل شيءٍ دون اعتبارٍ لآخرين يشاركونهم المآسي ذاتها، حقًّا: إن الأنانية أم الشرور كلها.
النازحون لا يتوقّفون عن الوفود إلى مراكز الإيواء غير المؤهّلة للاستخدام البشري، وغير القادرة على استيعاب الآلاف الذين يفقدون منازلهم يوميًّا في غزة. لا عودة للنازحين، لا في الشمال ولا في الجنوب، والخيمة قدرُهم، فوق حطام بيوتهم، أو مدارسهم، وجامعاتهم، ومساجدهم، وكنائسهم.
لا وقت لوداع الشهداء والحزن عليهم
أتأمل أحوال الناس، وحال الشقاء الملازم لهم: يستخرج بعض الأحياء جثث الشهداء المدفونة وقت الاجتياح عشوائيًّا؛ ليُعادَ دفنها في المقابر، لا وداعات للشهداء، ولا مواكب تشييع تنتظرهم، لا مجال لأن يبكي الرجال أو أن تلطم النساء، السعيد من يحظى بصلاة جنازةٍ مستعجلة على قبر، لا وقت لأن يعيش أحدٌ حزنه، الكل يلهثُ وراء كابوس النزوح، وشبح التشريد، وأمام طوابير المياه والخبز، وكوبونات الإغاثة..
يرحل آخرون من بيوتهم المهدمة، ومن أحيائهم المدمّرة؛ لينصبوا خيامًا، أتعجب من قدرنا مع الخيمة وأفكرُ دعاء أهلُ الخيامِ (في الشمال والجنوب) لربَّهم؟
فقد سمعت في طفولتي مناجاة يائسةً أو متفائلةً تدعوها جداتنا في فلسطين: ” يا أبو خيمة زرقا” يقصدن بذلك الله. ومناجاة الله عند الفلاحين بسيطةٌ مثلهم، ومخاطبته لا تحتاج تكلّفًا، ولا أدعيةً تردد حفظًاً دون وعيٍ، إذ يدعون ربهم بما عهدوه. أزلْ يا صاحب الخيمة الزرقاء الأحزان الموروثة المتناقلة عبر الأجيال.. فقد طال البلاء، وكثر دعاؤنا الذي ينتظر أن تفتح له أبواب السماء، وصار لزامًا علينا أن نستبدل تمتماتنا، فليس بيننا نبيٌّ تنحلّ به عُقدُنا، وتنفرجُ به كُرَبنا، ولا بيننا وليٌّ تكشَفُ له الحجب، وتقضى به الحوائج.
أسلي نفسي بإعادة قراءة الكتب التي ورثتها عن جدي الشهيد، واستأثرتُ بها في حياته، دونًا عن أخوالي المعتقَلين الذين نجهل مصيرهم، أو مكان اعتقالهم منذ أكثر من سبعة شهور.
يذكر الكتاب أن البولونيين (إبّان الاحتلال الألماني) قالوا إن هتلر لن يصمد إلى ما بعد الربيع، يبدو أنها ثقة الشعوب الدائمة في زوال العدوان، وجلاء الغُزاة. فقد رددنا طويلًا أن الاحتلال لا يستطيع الحرب على أكثر من جبهة، ولا يستطيع أن يخوض حربًا لأكثر من خمسة شهور. في شهرنا العاشر تحت العدوان، لا ندري إن كانت هذه الحرب التي استعرت في الخريف، ومرّ عليها برد الشتاء، ولم تقطف زهور الربيع، ستنتهي في هذا الصيف أو بعده. لا صفقة وشيكة محتملة تلوح في الأفق، على الرغم من كل الجهود الدبلوماسية العربية، والضغط العالمي، والحشود الجماهيرية المناصرة لحقوق الفلسطيني في غزة، أو حتى تلك الإسرائيلية الضاغطة على حكومة نتنياهو للقبول بالصفقة.
قبل المغرب بقليل، بعد عملي الشاقّ والمهلك، أستريح متأملًا فيما تبقى من البلاد، فيمتد الأزرق أمامي ثلاث من ثلاث جهات:
الخيمة الزرقاء على اتساعها فوقي، وزرقة البحر الذي يموج أمامي دون عمارات تحجبه عن ناظري رغم اتساع المسافة، وزرقة الأعلام الإسرائيلية التي ترفرف أعلى ساريةٍ في أقصى شمال غزة.
لقد كره العرب في تاريخهم اللون الأزرق، وعدّوه لون اللؤم والخسّة، إذ كان يذكرهم بصراعهم الوجوديّ والحضاريّ مع الفرس والإفرنج، الذي عرف عنهم زرقة العينين. حتى إنّ صورة الغول في المخيّلة العربيّة كانت بأنيابٍ زرق
كان الغول مستحيلًا عندهم، أما اليوم فهو حاضرٌ ماثلٌ طيلة الوقت بالأسلحة الانشطارية، والأحزمة النارية، والطائرات الحربية، ولا مناص من ملاقاتِه، وترقُّب أذاه دون وسيلة للدفاع، أو ردّ العدوان، قد تنتهي المواجهات بصفقةٍ يتفق فيها الخصوم، لكنّ حربنا الحقيقيّة ستكون بعد انتهائها، فالحرب تبدأ بعد أن تنتهي.
• بالتزامن مع مدونة: https://www.themfadhel.com/