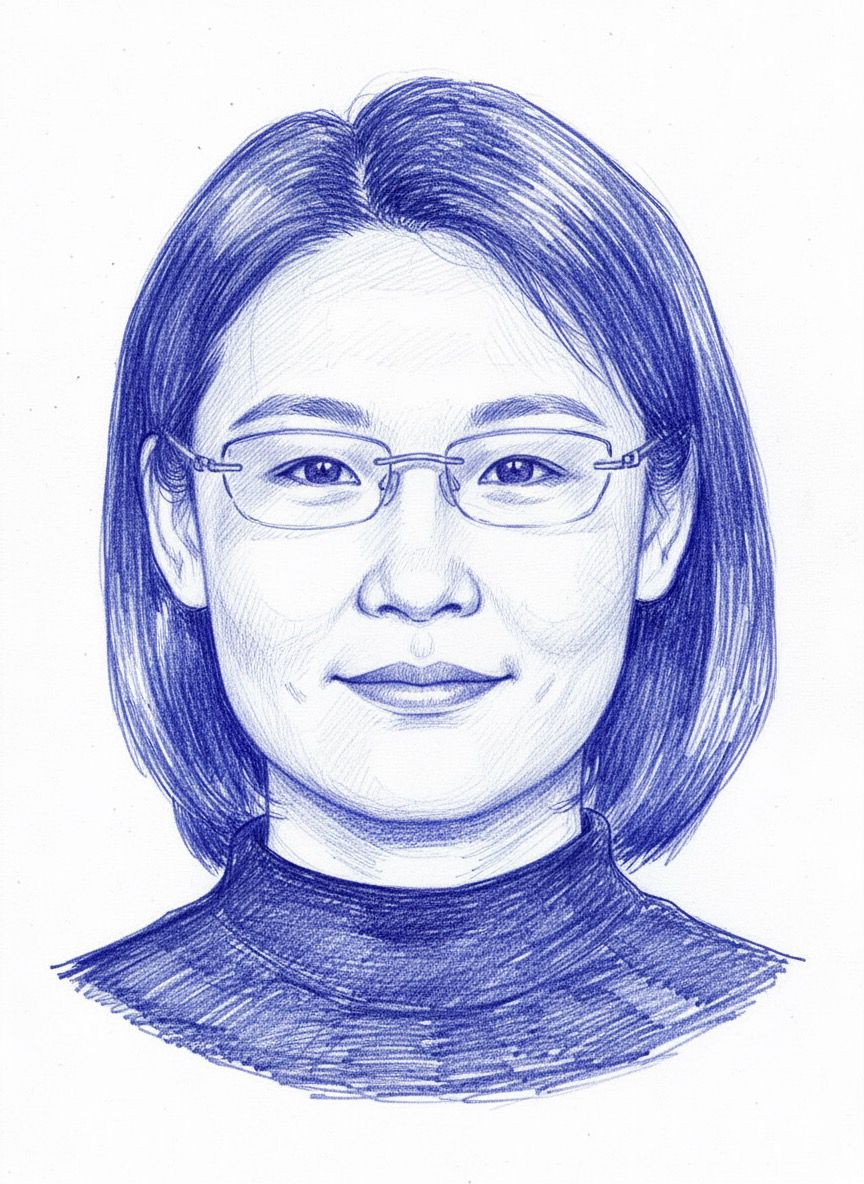لقد تنفَّسَ بي العمرُ، ورأيتُ الشَّيخَ المهندسَ محمَّدَ المقرمي، وجالستُه، وسمعتُ منه، وأفدتُ من فيوضِ ما أولاه الله من بصيرةٍ نافذةٍ، ثمَّ مضى في طريقه، فأضحى ما كانَ بيننا شطرًا من ذاكرةِ الوصلِ الممتدَّةِ إلى اللقاءِ السَّرمدي!
وكلَّما هممتُ بالكتابةِ عنه، وجدتُ ذاكرتي تحتالُ على الأشياء والمواقفِ والرؤى، وهي تعيدُ تعريفها واستنطاقها، وتشحنها بدلالاتٍ جديدةٍ من وحيِ تلميذٍ أضنتهُ لوعةُ الفقد، وهاجَ في صدره حنينُ مريد فقدَ أستاذَه الذي علَّمه طرائقَ السَّيْرِ إلى الله!
لطالما سمعتُ دررَ شيخِنا المقرمي، ووقفتُ أمامها كما وقفَ غيري مأخوذًا، ووجدتني أسائلُ نفسي: أيّ لذَّةٍ تلكَ التي تغمرُه وهو يتحدَّثُ عن الله؟ وأيّ نعمةٍ تلكَ التي انهمرت عليه، حتى فُتِح له هذا الفتح في الحديث عن كتابِ ربنا الجليل؟ فلما لقيتُه، أخذتُ أسأله عمَّا يختلجُ في صدري، وسمعتُ منه ما يهدي الحيران، وإنَّ الرجلَ لتعرفُ صدقَه من حديثه؛ فما رأيتُ أصدقَ لهجةً منه، ولا أصفى روحًا، ولا أهدى سمتًا.
إذا جلستَ بين يديه، رأيتَ رجلًا موصولًا بربِّه، أدركَ سرَّ الوجود، فنظَرَ إلى الدُّنيا كما ينبغي أن تُنظَر، فعاش موفورَ الإيمان، مطمئنَّ الجَنان، مسلِّمًا منقادًا لخالقه، حتى فُتِح له من فيوضِ العارفين ما يعجزُ اللسانُ عن وصفه.
وقد عاشَ الشَّيخ حياتَه المهنيَّة كأيّ إنسانٍ يطلبُ عيشًا كريمًا، فكان مهندسًا للطيران، جابَ الآفاق، وتعرَّفَ إلى عوالمِ النَّاس، ورأى ما لم نره نحن، فلم تغرَّه الزخارف ولا بهرَه اللمعان.
عاش عمرًا في مهنته، ثمَّ طوى بساطها وأقبلَ على خاصَّةِ نفسه، روَّضها حتى انقادت لأمرِ الإله، واعتزل ضوضاء الحياة، ليعيش عزلةً قرآنيّةً خالصةً ستّ سنين، قضاها منكبًّا على التِّلاوة والتَّدبُّر، حتى بلغَ من الأنسِ بالقرآن أن يختمه في يومٍ واحد.
ولما أعطى القرآنَ عمرَه ولبَّه، منحه القرآنُ من أنواره وأسراره وهباته ما لا يُمنح إلا لأوليائه.
وأحسِبُ أنَّ الرجلَ قد فُتِحَ له، فقد وهِبَ تدبّرات وهدايات ولطائف عزيزة لا تراها في كتاب، وأنوارٌ تشرقُ من كلماته إشراقَ الفجر في ظلمِ الليل، يقرأ القرآن كأنَّه صفحةٌ واحدة، يصل الآيةَ بأختها، ويضمُّ النَّظيرَ إلى نظيره، فيستخرجُ معنىً دقيقًا تُعجبُ لجماله وبهائه.
وإنكَ لتظنُّ الأمر يسيرًا، فإذا حاولتَ مثله تعذَّر عليك، فثَمَّ حُجُبٌ لا تنكشفُ إلا لمن أخلصَ قلبه، فابحثْ عن المانعِ الذي يحول بينكَ وبين أسرارِ الكتاب، حتى تكون من أهل الورد والأنس بالنص الإلهيِّ الخالد الذي لا ينقطعُ مدده.
وقد ضمَّ إلى فقه القرآن فهمَه العجيبَ للحديثِ النَّبوي، فيتحدَّثُ عن حديثٍ مألوفٍ بين النَّاس، فيأتي بفهمٍ عزيزٍ، ورؤيةٍ تقرِّبُ البعيد، ويربطه بالآية ربطًا بديعًا يريك تمام الصورة حين يُضمّ قولُ الحبيب ﷺ إلى خطاب الربّ جلَّ جلاله. ولا أرى إلا أنَّ نورَ القرآن قد قُذِفَ في قلبه، فألهمه تلك المعاني الجليلة التي يجري بها لسانه بلا تكلّف، كأنّه يقرأ من لوحِ الغيب.
ومن محاسنه التي خبرتُها فيه أنه لا يتكلّم إلا فيما يحسن، تراه في المجلس الكبير كالتَّلميذ، يصغي بأدبِ المريد، فإذا سُئِلَ عمَّا يعلم أجاب، وإلا آثر الصَّمت، لا يتشوَّف للكلام ولا يتطلَّع إليه، فإذا شرعَ فيه انفتحَ له بابُ الرِّزق وقال: «هذا رزقُكم!»
وإني والله ما سمعتُ أحدًا يتحدَّث عن كمالِ التوحيد كما صنع المقرمي، ولا رأيتُ رجلًا تجسَّدت فيه المفاهيمُ الكبرى التي تصوغُ الإنسانَ ليرتقي معارجَ الكمال كما رأيتُها فيه بيّنةً جليَّة؛ فهو ترجمةٌ حيَّة لمعنى الزَّاهدِ العابدِ العارفِ بالله، الرجلِ الذي تحمله الحياةُ ولا يحملُها، يرى اللهَ في كلِّ شيء، وأقصى أمانيه أن يعيشَ اللحظةَ كما أرادها الله؛ فإذا بلغ المرءُ تلك الحال، فقد ارتقى إلى مقاماتِ الأبرار الذينَ نوَّهَ اللهُ بذكرِهم، وجعلهم مثالَ الهدى في طيِّ كتابه.
وكان أعجبَ ما رأيتُ فيه أنه لا همَّ له إلا أن يدلَّ العبادَ على الله، ويُرشدهم إلى الاطراح بين يديه. لا ينسِبُ لنفسهِ شيئًا، فإذا رأى مريدًا تعلَّقَ به أبعده عن ذاته وأحاله إلى مولاه. قلتُ له بعد رحيله: «افتقدتُك شيخَنا»، فقال لي: «من وجدَ الله ما افتقدَ شيئًا». وبعيدَ سفره حزَّ الفراقُ في نفسي، وأحسستُ كأني أمسيتُ في ضميرِ الكونِ وحيدًا، فقلتُ له: «لقد تركتَ في قلبي فراغًا وحُزنًا»، فقالَ: «من استأنسَ بالله ما استوحشَ من أحد، ومن اعتزَّ بالله ما ذلَّ، ومن استغنى بالله ما افتقر، ومن اعتصمَ بالله فقد هُديَ إلى صراطٍ مستقيم».
وإذا نظرتَ إلى حاله رأيتَ نموذجَ التَّدينِ الفطريِّ المشرق، الذي يقصد الله في كل أمر، تدينٌ يجمعُ رقّةَ التصوف، وكمالَ التَّوحيد، وصفاءَ التوكل، ولين الجانب، والنَّأي عن الشَّكليات التي شوَّهت التَّدين وقزّمته، وأبعدته عن الغايةِ الكبرى. بدا لي في صورةِ المتديِّنِ المحبّ للحياة، المتشوِّقِ إلى لقاءِ مولاه، تدينٌ لا عِللَ فيه، نابعٌ من نورِ الكتاب، مؤيَّدٌ بنفَحاتِ الله، تراهُ يسير بين النَّاس وقلبه معلقٌ بالعرش!
ولا أزعم المبالغة؛ فالرجل يتكلُّم بلسانِ الحكمة، وفي بعض قوله اختزالُ فيلسوفٍ خبرَ الحياةَ حتى أفاضت له بأسرارها. له تجارِبُ تستحقُّ أن تُروى، ومواقفُ تَستدرُّ الإنصات، وهو في جميع حالاته ذاك الرجل البسيطُ المتواضع، المرح، لا همَّ له إلا أن يأخذَ بيد الإنسانِ إلى خالقه.
ولقد صحبتُه في زيارةٍ إلى قومٍ من الدُّعاة، فقامَ رجلٌ منهم وقال: «بعضُ محاضراتكم فُرِّغت وطُبعت، وأضحت زادًا للدُّعاة في بلادٍ بعيدة»، فما كان من الشَّيخ إلا أن طأطأ رأسه، وحمد الله، ثم قال لي بعد خروجنا: «ما أتى الله بي إلى هذه البلاد إلا لأسمع هذه البشرى، وقد قبلتها». ورأيته بعد أيامٍ يردِّد الموقفَ شاكرًا ربَّه: «أيّ شكرٍ يفي بفضل الله؟ عبدٌ من قرية المقارم في سفحِ جبل، يقول كلامًا يبلغ الآفاق! اللهم لا تجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون». وكان يكرهُ سؤال: «ما جديدكم يا شيخ؟» فيقول: «لستُ مطربًا يُنتظَر جديدُه، اعملوا بما سمعتم ففيه الفلاح!».
وقد لمستُ من بركةِ صحبته وطولِ مجالسته أثرًا لا يزولُ من نفسي وضميري، وإني لأرجو الله أن يجعلنا تلاميذ بررة لهذا الرجل الذي عاشَ بالقرآنِ وله، حتى غدت تجرِبتُه آيةً في القَبول، وعَلامة على عطاءِ الله المدهِش لعبادِه.
ولعلي أرجئُ الحديثَ عن منهجه في تناول القرآن إلى مقامٍ آخر، أبسطُ فيه القولَ، لتبدو تجرِبتُه مدرسةً قرآنيةً يمانيةً إيمانيةً، يبقى أثرُها، ويعمُّ صداها، تقصدُ اللهَ وحده، وتُعلي من سلطانِ الوحي ومركزيتِه في شؤون الحياة؛ فما خابَ من تشبَّثَ بالكتابِ العظيم، ولا ضلَّ من استمسكَ بالعروةِ الوثقى!
وما زال الشَّيخُ يمشي في النَّاسِ بضياءِ القرآن، ينفخُ في القلوب روحَ الوحي، ويغرسُ في العقول معنى العبودية، يذكِّرُ الخلقَ بربِّهم، ويصنعُ من الكلمةِ سبيلًا إلى السَّماء.